
القضاء والسياسة
الأبعاد السياسية في إصلاح منظومة العدالة
بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (وجدة)
إن إصلاح منظومة العدالة في أي مجتمع، لا يُمكن أن تتم إلا ضمن التوجهات الكبرى بهذا الخصوص، والتي يعرفها المجتمع الدولي، وأثرت بشكل أو بآخر، ولو بدرجات متفاوتة، على التجارب الوطنية.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن التقسيم الكلاسيكي للسلطات العمومية، والقائم على وجود سلطتين سياسيتين (تشريعية وتنفيذية)، إلى جانب سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، قد بدأ يعرف تحولا عميقا يُؤدي تدريجيا إلى تغيير ملامحه شكلا ومضمونا. لقد أصبح عاديا أن نتحدث مثلا عن الحكومة باعتبارها “المشرع الرئيسي” استنادا إلى تحكمها وهيمنتها على المسطرة والعمل التشريعيين إلى جانب كونها صاحبة “السلطة التنفيذية، كما أصبح من العادي جدا الحديث عن تحول البرلمان من سلطة تشريعية إلى “سلطة تداولية”.
وإذا كان هذا التحول مسألة طبيعية نتيجة تأثير النظام الحزبي وعوامل سياسية أخرى، فإن النظر إلى السلطة القضائية ظل لفترة طويلة بعيدا عن هذه التحولات، ولم يكن محط اهتمام مباشر إلا بالموازاة مع النقاش حول ظهور وتطور القضاء الدستوري والإداري من ناحية، وخلال المحاكمات السياسية الكبرى التي تُعرض أمام القضاء من ناحية أخرى (بعض قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي بفرنسا، تطور مراقبة دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم سواء عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم أو عن طريق دعوى الإلغاء أمام محاكم يتم إحداثها خصيصا لهذا الغرض، النقاش حول مفهوم “الجريمة السياسية”، محاكمات كبرى أخذت طابعا سياسيا من قبيل محاكمات نورمبيرغ وفيشي…).
في ظل هذه التطورات، برز بشكل واضح تطور من جانبين:
– من جانب أول، لوحظ أن هناك ميل لتسييس القضاء بواسطة دفعه إلى اتخاذ مواقف من خلال النظر في قضايا ذات طابع سياسي محض (Politisation de la justice)؛
– ومن جانب ثاني، لوحظ أن هذا التطور يفرض فتح المجال أمام القضاء من أجل النظر بأشكال متزايدة، في هذا النوع من القضايا من خلال إخضاع الممارسة السياسية لسلطة القضاء (Judiciarisation ou juridictionnalisation de la politique).
ومن خلال هذين التطورين، وجدت العدالة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها القضاء، تعمل بشكل يجعل القاضي في نفس وضعية الوزير أو النائب البرلماني أو المنتخَب بصفة عامة، أو حتى الفاعل الجمعوي، فأصبح الطابع السياسي لعمله أوضح مما كان عليه سابقا.
وقد أثر هذا التوجه العام، على التجربة المغربية، التي أصبح الآن من المهم الوقوف على مدى تأثرها به، والتعرف على المدى الذي وصلت إليه، وخاصة من ذلك الوضعية القائمة على ضوء مستجدات المراجعة الدستورية الأخيرة وما ترتب عنها من فتح أوراش إصلاحية مختلفة.
لذا، سأحاول الإجابة على هذا الموضوع، من خلال الإشكاليات التالية:
– هل يتعلق الأمر بخلق وترسيخ سلطة ثالثة (السلطة القضائية) لخلق توازن بين/مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم خلق سلطة ثالثة مستقلة ومحايدة لخلق توازن بين السلطة (بمفهومها العام) والمجتمع؟
– هل يُمكن اعتبار مستجدات الدستور بخصوص السلطة القضائية، نقطة انطلاق لتغيير طبيعة ودور القضاء، أم نقطة نهاية للنقاشات السابقة؟
– هل يتعلق الأمر بدور القضاء لوحده داخل منظومة العدالة، أم بكل الفاعلين في المنظومة (وزارة العدل، محامون، أعوان القضاء، كتاب الضبط، …)؟
– وأخيرا ما مدى تأرجح إصلاح منظومة العدالة بين التوجهين الدوليين: تسييس القضاء أم إخضاع السياسة للقضاء؟
أعتقد أن الوصول إلى خلاصات أولية بخصوص كل هذه الإشكاليات، للوقوف على درجة تسييس السلطة القضائية، يقتضي فهم شروط وظروف عمل القضاء حينما لم يكن إلا مجرد وظيفة (المحور الأول)، ثم الوقوف على مستجدات الدستور في المواضيع ذات الصلة (المحور الثاني)، وأخذ بعض النماذج من القوانين التنظيمية، وخاصة دور القضاء أساسا في موضوعي الأحزاب السياسية والانتخابات (المحور الثالث).
المحور الأول: القضاء الوظيفة
ظل القضاء المغربي لفترة طويلة مؤطرا من قبل دساتير تشير إليه دون “هوية”، وهو ما جعل جل المحللين من أكاديميين وسياسيين يُجمعون على أن “القضاء” ليس إلا مجرد “وظيفة” لا ترقى إلى مرتبة “سلطة”. ومما زاد في تكريس هذا التحليل، الواقع الذي كان القضاة يعملون في إطاره.
فانطلاقا من دستور 1962، لم يُخصص للقضاء إلا المقتضيات التالية، وهي مقتضيات لم تعرف أي تعديل جوهري إلى غاية دستور 2011[1]:
- الفصل 82: القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
- الفصل 83: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
- الفصل 84: يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- الفصل 85: لا يعزل قضاة الإحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
– الفصل 86: المجلس الأعلى للقضاء يرأسه الملك ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الرئيس من:
– وزير العدل خليفة للرئيس؛
– رئيس المجلس الأعلى؛
– النائب العام لدى المجلس الأعلى؛
– رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى؛
– نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم؛
– نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم؛
– ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم.
الفصل 87: يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
وقد أدى قصور هذه المقتضيات الدستورية إلى إفراز مجال قضائي متميز أساسا بالمظاهر التالية:
1-ضعف الاستقلال العضوي (وحتى الوظيفي) تجاه السلطة التنفيذية القوية التي طمست استقلاليته، سواء على مستوى الدور الذي مارسه الملك من جهة، أو وزارة العدل من جهة ثانية، ودون أي دور يُذكر على مستوى العلاقة مع أعضاء البرلمان نتيجة الحصانة البرلمانية القوية، وعدم وجود مراقبة لدستورية القوانين، وعدم إمكانية محاكمة الوزراء أمام القضاء العادي عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء مارستم لمهامهم؛
2-وجود هيئات منافسة ذات طبيعة قضائية: المحكمة العليا للعدل[2]، محكمة العدل الخاصة[3]، المحاكم العسكرية[4]، محاكم الجماعات والمقاطعات، المجلس الأعلى للحسابات[5]…، وهو ما جعل القضاء يعمل فقط على مستوى البت في القضايا ذات الصبغة القانونية المحضة، المتعلقة بالنزاعات، وضمن شروط عمل صعبة؛
3-الانحياز الواضح إلى جانب السلطة في مواجهتها للمعارضة بكل أشكالها: محاكمة المعتقلين السياسيين والنقابيين، أو المشاركين في الحركات الاحتجاجية، أو الصحفيين …
4-اعتماد مواقف تبريرية فرضتها طبيعة النظام السياسي بالمغرب، نشير من بينها إلى القضايا المرتبطة بممارسة الملك للاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، والتي ظل القضاء يبحث لها عن مبررات لإخراجها من دائرة مراقبة القضاء الإداري، ليُتوج ذلك بحكمه الشهير في قضية “مزرعة عبد العزيز” التي احتمى بخصوصها بإمارة المؤمنين[6]؛
5-انعدام الجرأة في معالجة القضايا المرتبطة بالمجال السياسي: حالة الحصانة البرلمانية، أو حالة عدم القدرة على الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية الغير متفقة مع الدستور رغم وجود مقتضى دستوري منذ دستور 1992 ينص صراحة على أنه “لا يجور إصدار أو تطبيق أي نص يُخالف الدستور”[7] وفق قاعدتي (النص الأعلى يُلغي النص الأدنى، والنص اللاحق يُلغي النص السابق)؛
6-عدم ممارسة أي دور خلال مرحلة تصفية مخلفات “سنوات الرصاص”، وهو ما جعل القضاء خارج نظام العدالة الانتقالية.
إن هذه المظاهر “الضاغطة” على مرفق القضاء، قد جعلت شروط العمل في غير صالح القضاة. أضف إليها كل ما يرتبط بانعدام حقهم في التنظيم الجمعوي المستقل، وحرية التعبير والاحتجاج …
لقد أصبح القضاء بحكم هذا الواقع، وظيفة بعيدة عن النقاش العمومي، وغير مساهمة فيه، إلا عرضيا في مجالات محددة، نُذكر منها:
1-مطالب الأحزاب السياسية باستقلالية ونزاهة القضاء بسبب ما كان يتعرض له مناضلوها وصحافتها؛
2-النقاش الأكاديمي حول “الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى” في اتجاه المطالبة بمجلس دستوري كهيئة مستقلة عضويا، مع توسيع صلاحيتها لتشمل مراقبة دستورية القوانين، وهو ما تبنته الأحزاب السياسية لاحقا؛
3-المد الحقوقي الذي فرض إنشاء محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي لوضع حد لنظام وحدة القضاء، وبالتالي إعادة النقاش حول دور القضاة في الحد من تعسفات رجال الحكومة والإدارة[8]؛
4-اصطدام القضاء بقضايا سياسية مباشِرة في حالات معينة، قضية حل الحزب الشيوعي المغربي والحيثيات السياسية الواضحة الواردة فيه، قضية صحافة “ماص”، ثم لاحقا قضايا ذات صلة بتأسيس أو حل أحزاب سياسية (الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي[9]، الحزب الليبرالي المغربي، حزب الأمة[10]، وحزب البديل الحضاري[11]).
في ظل هذه الشروط، كان واضحا أن ردة الفعل ستكون قوية، وهو ما سيتضح من خلال مستجدات المراجعة الدستورية الأخيرة التي سنحاول تحليل أبعادها السياسية.
المحور الثاني: القضاء السلطة
شكل النقاش العمومي خلال المرحلة الممتدة من الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 إلى غاية استفتاء فاتح يوليوز 2011، محطة أساسية لتبادل الآراء بخصوص المكانة المرتقبة آنذاك للقضاء. وقد كان لتنوع طبيعة المساهمين دورا حاسما في ترسيخ الخطوط العريضة لما ينبي دسترته. فإلى جانب المساهمة التقليدية للأحزاب السياسية، شاركت المنظمات النقابية، ومجموعة واسعة من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والهيئات والتنظيمات المهنية، ومساهمات أكاديمية، وحتى مشاريع فردية.
لقد أفرز هذا التنوع خطوطا عامة كانت بمثابة حد أدنى لا يُمكن القبول بما دونه: سلطة قضائية مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد كان من الطبيعي أن يترتب عن هذا التوجه نتائج كانت كلها في صالح تدعيم مكانة هذه “السلطة الجديدة”.
وإذا كانت مداخلات أخرى خلال هذه الندوة قد عالجت كل المستجدات التي جاء بها الدستور، فإنه من المهم الآن البحث فيها من زاوية الموضوع الذي نُعالجه، وخاصة من ذلك: معالم تسييس القضاء وإرهاصات إخضاع الممارسة السياسية للقضاء، آخذين بعين الاعتبار التداخل بين هذين التوجهين والحدود “الغامضة” بينهما.
أولا: السلطة القضائية: un Pouvoir أم une Autorité ؟
رغم تأثر جل المساهمين في النقاش العمومي بالتجربة الدستورية الفرنسية، فإن مناقشاتهم ول “السلطة” القضائية لم تستحضر ما سيقابلها كمصطلح باللغة الفرنسية. فقد كان الهدف هو ترسيخ المبدأ أولا وأساسا، وبالتالي غاب البُعد السياسي في ذلك النقاش، وكانت النتيجة أن تم اعتماد مصطلح Pouvoir رغم أهمية استعمال مصطلح Autorité الذي استعمله الدستور الفرنسي.
وأعتقد أن اختيار المصطلح يحمل في طياته إجابة تدل على توجه معين: فهل نريد قضاءً مستقلا في اتخاذ قراراته وأحكامه بدون أي تدخل من أي جهة كانت، أم نريد قضاءً يقف بشكل متساو مع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
وإذا كان الدستور قد ذهب في الاتجاه الثاني، فإن مفهوم Pouvoir فعلا أصلح بكثير من مصطلح Autorité الذي رغم يدل على سلطة حقيقية تُعتبر جوهر العمل القضائي: سلطة البت، القادرة وحدها على الوقوف في وجه شطط وتجاوزات السلطة الإدارية Autorité administrative، على العكس من Pouvoir الذي يُقربك من مفهوم ذو طبيعة سياسية لا تدل بالضرورة على القدرة على البت دون تدخل أو ضغط خارجي. وقد سبق أن أشرنا بهذا الخصوص مثلا إلى أن البرلمان سلطة تشريعية POUVOIR législatif ومع ذلك لم يعد يملك استقلالية البت لوحده في قضايا التشريع التي هي جوهر وجوده، وعن الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية POUVOIR exécutif في الوقت الذي لا زال فيه مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك يمتلك جوهر الصلاحيات الحكومية.
لذا، فإنني أعتبر أن هذا الخيار منطلقا مهما للحديث عن تسييس القضاء الذي هو جوهر بحثنا.
ثانيا: سلطة القضاء على أعمال السلطة التشريعية
شكل تحويل المجلس الدستوري إلى “محكمة” دستورية، عملية ذات دلالات هامة، إذ من خلالها تم إخضاع العمل التشريعي للمراقبة، خاصة من زاوية النظر في مدى مطابقته للدستور.
لقد سبق أن كان القضاء من خلال “الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى” ينظر في مدى مطابقة الأنظمة الداخلية للبرلمان والقوانين التنظيمية للدستور، إضافة للنظر في الطعون الانتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان، وبالتالي فقد كان للقضاء كلمته باعتبار أن هذه “الغرفة” كانت جزءً من التنظيم القضائي إلى جانب الغرفة الإدارية والمدنية والاجتماعية … بالمجلس الأعلى الذي كان بمثابة محكمة نقض. وقد تغيرت طبيعة الغرفة عند تحويلها إلى مجلس دستوري، لكن العودة لنظام “المحكمة” يدل على توجه إيجابي، خاصة مع إضافة صلاحية النظر في مدى دستورية القوانين العادية سواء تم ذلك بطلب شخصيات أو مجموعات سياسية حددها الدستور، أو من قبل المواطنات والمواطنين في إطار الدفع بعدم دستورية القوانين.
وللإشارة، فإن توسيع مجال القانون في الدستور لا يعني إلا توسيع صلاحية تدخل المحكمة الدستورية في قضايا التشريع.
ثالثا: سلطة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية
تضمن الدستور العديد من أوجه “تدخل” القضاء في أعمال السلطة التنفيذية، والتي تُرسخ التوجه الذي نريد البرهنة عليه. فمن جهة أولى نلاحظ أن أعضاء الحكومة اللذين ظلوا لفترة طويلة مسؤولين أمام “المحكمة العليا” (المشكلة من أعضاء البرلمان) عما يرتكبونه من جرائم وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، أصبحوا الآن مسؤولين أمام محاكم المملكة كباقي المواطنات والمواطنين، ومن جهة أخرى فإن الدستور اعتبر أن “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”، وهو ما سيضع حدا للحديث عن أية استثناءات، بل سيُعيد النقاش إلى بدايته خصوص القرارات الملكية المتخذة في المجال الإداري حتى ولو كانت في شكل “ظهير”، وستبقى أعمال السيادة وتلك المرتبطة بإمارة المؤمنين خارج النقاش.
رابعا: سلطة القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات
توسع تدخل القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات بأشكال متعددة. فانطلاقا من الفصل 117 من الدستور، والذي جاء فيه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”، يُمكن القول إن السلطة القضائية تتحمل الدور الأساسي في تحقيق “الأمن الحقوقي” سواء من خلال المجالات التقليدية المرتبطة بقوانين الحريات العامة (الصحافة والنشر، تأسيس الجمعيات، التجمعات العمومية)، أو من خلال الضمانات التي يُقدمها القضاء نفسه انطلاقا من مرحلة توجيه التهمة إلى غاية تنفيذ العقوبة، مرورا بتوفير شروط المحاكمة العادلة، أو من خلال ما أصبحت تقوم به المحكمة الدستورية بخصوص مراقبة دستورية القانون التي أسند له الدستور الحق في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أو الحد منها، أو ضمان حقوق المعارضة من خلال النظر في القوانين التنظيمية أو القوانين أو الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، والنظر بصفة عامة في كل القوانين التنظيمية ومنها حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع أو تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
هذا، ونشير إلى أن مسألة إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، ستفرض بالضرورة إحداث “جهاز” قضائي يبت في جدية الدفع قبل إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية.
خامسا: سلطة القضاء في المجال التأسيسي
إضافة للعمل التقليدي الذي كان يقوم به المجلس الدستوري بخصوص إعلان نتائج الاستفتاءات، أصبحت المحكمة الدستورية قادرة على فرض تعديل الدستور انطلاقا من الدستور الذي جعل تصريحها بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يُخالف الدستور، يترتب عنه أن المصادقة لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
كما أن مسطرة مراجعة الدستور قد عرفت تعديلا جوهريا من خلال مستجدات الباب الثالث عشر، حيث أنه إضافة إلى المسطرة التقليدية المتمثلة في عرض مشاريع ومقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، فإنه بمقتضى الفصل 174، تم إحداث مسطرة خاص بمراجعة “بعض مقتضيات الدستور” تراقب بموجبها المحكمة الدستورية صحة الإجراءات، وتُعلن النتيجة، رغم أن المبادرة تكون من الملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وأنه يتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها في اجتماع مشترك لمجلسيه، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
سادسا: سلطة القضاء في مجال توقيف وحل التنظيمات
لقد أصبح للقضاء دورا مركزيا تجاه أنواع كثيرة من التنظيمات، بحيث أنه صار من غير الممكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقرر قضائي، كما أنه لم يعد ممكنا حل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أو توقيفها إلا وفق نفس المسطرة.
وتظهر أهمية هذه المقتضيات في مجال تسييس القضاء من زاوية الدور الواضح للأحزاب السياسية في تأطير العمل السياسي من جهة، وما نلاحظه من علاقة متزايدة بين النقابي والسياسي من جهة أخرى، إضافة لكون هيئات المجتمع المدني أصبحت بدورها تُساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخَبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، مما سيجعل القضاء يواجه قضايا سياسية بشكل أو بآخر.
إن هذه النماذج، كافية لوحدها للحديث عن مكانة متزايدة للسلطة القضائية داخل الحق السياسي، وينبغي أن نضيف إليها المكانة التي أصبح يحتلها ضمن باقي المؤسسات الدستورية (التقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة والآراء المفصلة التي سيقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانفتاح على مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يُعينها الملك لعضوية المجلس الأعلى، منع إحداث المحاكم الاستثنائية، المكانة المتميزة للمحكمة الدستورية ومختلف الاستشارات التي يقدمها لمؤسسات دستورية أخرى، تخصيص باب مستقل للمجلس الأعلى للحسابات الذي هو “محكمة للحسابات”، … ).
إلا أن هذا التأطير الدستوري لمكانة وصلاحيات السلطة القضائية غير كاف لوحده، ذلك أن الوصول إلى خلاصات أولية في الموضوع يستلزم المزيد من البحث في مجالات تسييس القضاء خارج المقتضيات الدستورية.
المحور الثالث: القضاء والأحزاب السياسية والانتخابات
إن المزيد من البحث في المجالات التي يُمكن أن “يصطدم” فيها القضاء بمواضيع ذات طبيعة سياسية، يقتضي أيضا البحث في النصوص التشريعية، التنظيمية والعادية. ومن هذه الزاوية سنلاحظ الدور المركزي الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق مقتضيات قوانين الحريات العامة، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وقضاء الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، ثم قضاء التعويض، والمنازعات الجبائية، والمنازعات الانتخابية، …
وإذا كان المجال هنا لا يسمح بتفصيل كل هذه المواضيع، فإننا سنقتصر على مثالين يوضحان المدى الذي تصل إليه هيمنة القضاء على مجالات سياسية بامتياز، ويتعلق الأمر بالأحزاب السياسية (أولا)، والانتخابات (ثانيا).
أولا: الأحزاب السياسية
منح القانون التنظيمي للأحزاب السياسية[12] دورا مهما للسلطة القضائية في مجالات عديدة، يُمكن تقسيمها إلى ثلاثة:
1-على مستوى التأسيس، نلاحظ أنه:
– تتلقى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط نسخة من ملف التأسيس موجهة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 6)؛
– تبت المحكمة الإدارية بالرباط في طلب رفض التصريح بتأسيس الحزب بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 7)؛
– تبت المحكمة الإدارية بالرباط في طلب إبطال تأسيس الحزب، كما يُمكن لرئيس المحكمة أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب لين البت في طلب إبطال تأسيسه ويُنفذ أمره على الأصل، وكل ذلك الحزب بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 13)؛
– تبت المحكمة الإدارية بالرباط في طلب رفض كل تغيير على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه (ولو صادق المؤتمر الوطني للحزب على ذلك) بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 14)؛
– تبت المحكمة الابتدائية المختصة في كل تغيير أو تصريح محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن “كل ذي مصلحة” (المادة 18)، في الأمور التي تهم:
كل تغيير في التسمية أو النظام الأساسي للحزب أو البرنامج (المادة 14)؛
كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي أو يهم مقر الحزب (المادة 15)؛
كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، أو كل تغيير يطرأ على هذه الأنظمة (المادة 16).
2-على مستوى التوقيف والحل والجزاءات الحبسية أو المالية:
تم تخصيص الباب السادس من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لموضوع الجزاءات، وهو باب يتضمن 11 مادة، تتضمن مجموعة متنوعة من الجزاءات. فبالإضافة لما يتعلق بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة لا يُمكن أن تقل عن شهر ولا تتعدى أربعة أشهر، أو مسألة طلب حل الحزب (المواد من 60 إلى 64)، فإن باقي مقتضيات الباب السادس تحتوي على جزاءات مختلفة حسب طبيعة الأفعال المرتكبة من قبل المعنيين، تنطلق، في الجانب المتعلق بالسجن من سنة واحدة إلى عشر سنوات، وفي الجانب المتلف بالغرامات من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم المواد من 65 إلى 70) مرورا بإغلاق مقار الحزب، ومنع اجتماعات أعضاءه، وتحديد كيفية تصفية أموال الحزب في حالة ما إذا لم ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب أو لم يقرر المؤتمر الوطني في ذلك.
3-على مستوى مراقبة التسيير المالي
– وفق المادة 44، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية والمشهود بصحتها من قبل خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المشار إليها في المادة 42، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها والمحددة بالمادة 32.
ويُمكن أن تصل العقوبات في هذا الصدد، إلى حد فقدان الحق في الاستفادة من الدعم السنوي المحدد في المادة 32 برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
– وفق المادة 45، يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب سياسي معني برسم مساهمة الدولة في تمويل الملات الانتخابية.
ويُمكن أن تصل العقوبات هنا إلى فقدان الحزب لحقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
ثانيا: الانتخابات
يُمكن اعتبار الانتخابات بمختلف أنواعها مجالا خاضعا بامتياز للسلطة القضائية، وذلك نظرا للدور المركزي الذي يلعبه القضاء والقضاة في هذا الصدد. ويهم الأمر الانتخابات التالية:
– انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين[13]؛
– انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الثلاثة[14] (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات)؛
– انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأربعة[15] (الغرف الفلاحية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري).
وإذا كان المجال لا يسمح باستعراض كل هذه الأنواع والدور الذي يمارسه القضاء في هذا الصدد، فإننا سنأخذ كنموذج انتخاب أعضاء مجلس النواب أساسا من خلال القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبعض مقتضيات مدونة الانتخابات.
1-خصص القانون التنظيمي لمجلس النواب، الباب السادس لتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها (من المادة 38 إلى المادة 69، أي ما مجموعه 32 مادة).
ومن خلال هذه المقضيات، نستنج أنه للقضاء سلطة واسعة تمتد بالنسبة للعقوبات المالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، وبالنسبة للعقوبات الحبسية من شهر إلى عشرين سنة، ما لم تكن هناك عقوبة أشد في القانون الجنائي.
مع ملاحظة أنه تم استعمال “و” مما يعني عقوبة حبسية ومالية في نفس الوقت في جل هذه العقوبات، وليس الاختيار بين عقوبتين في إطار السلطة التقديرية للقاضي.
وبالإضافة لهذه العقوبات، للقاضي الحق في مضاعفة العقوبة عند حالة العود، مع إمكانية الحكم الحرمان من التصويت لمدة سنتين، أو الحرمان من الترشيح لمدة تصل إلى فترتين نيابيتين متتاليتين حسب الحالة. وتشمل هذه العقوبات كل الأفعال المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية.
2-تلقي المحكمة الابتدائية لدارة النفوذ بنظير من محضر المكتب المركزي ولوائح الناخبين، مضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمتنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت (المادة 82)؛
3-رئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه للجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات (المادة 83)؛
4- تلقي المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات نظيرا من نظيرا من عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، مع حمل نسخة إلى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، كما أن رئاسة اللجنة الوطنية للإحصاء تعود لرئيس غرفة بمحكمة النقض وعضوية مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يعينهما الرئيس الأول لهذه المحكمة، وهي التي تضع محضر نتائج الانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية، وتُرسل نظيرا من المحضر للمحكمة الابتدائية بالرباط، ونظيرا للمحكمة الدستورية (المادة 85).
5-تم تخصيص الباب السابع للمنازعات الانتخابية. ويتضمن هذا الباب فرعين:
– الفرع الأول، خاص بمنازعات رفض التصريح بالترشيح حيث تنظر فيها المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية، وتنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. والملاحظ هنا هو أن المحكمة الابتدائية تبت بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربع وعشرين ساعة من ساعة إيداع الشكوى (المادة 87).
– الفرع الثاني، خاص بالعمليات الانتخابية حيث تنظر المحكمة الدستورية في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء (المادة 88)، وفق محددات عامة وضعتها المادة 89 بخصوص الحالات التي يُمكن معها الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا.
6-نشير في الأخير إلى أن القضاء يراقب أيضا المصاريف الانتخابية من خلال مقتضيات مدونة الانتخابات:
المـادة 291 التي توجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف مرفقا بالوثائق المشار إليها في المـادة 290 أعلاه؛
والمـادة 292 التي أحدثت لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية، تتألف من:
- قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛
- قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل؛
- ممثل لوزير الداخلية؛
- مفتش للمالية يعينه وزير المالية.
ووفق المـادة 293، فإن اللجنة، إذا لاحظت أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا القانون، أحالت الأمر على الجهة القضائية المختصة.
وينطبق نفس الأمر على المنتخَبين الجماعيين، حيث يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها (المـادة 294).
خاتمة وخلاصات:
بالعودة إلى الإشكاليات التي طرحناها في المقدمة، ومن خلال وجهة النظر هذه يبدو أن الخلاصات الأولية تتمثل فيما يلي:
– إن المشرع الدستوري حاول إقامة نوازن بين بخلق وترسيخ سلطة ثالثة (السلطة القضائية) لخلق توازن بين/مع السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إخضاع جوانب مهمة من أعمالهما لسلطة القضاء، وبين خلق سلطة ثالثة مستقلة ومحايدة لخلق توازن بين السلطة (بمفهومها العام) والمجتمع من خلال إسناد حماية الحقوق والحريات للقضاء لمراقبة مدى الحدود التي يُمكن للسلطة التشريعية أن تدخلها عليها، ومراقبة تصرفات الإدارة بهذا الخصوص.
– يُمكن اعتبار مستجدات الدستور بخصوص السلطة القضائية، نقطة انطلاق لتغيير طبيعة ودور القضاء، وليس نقطة نهاية للنقاشات السابقة، ما دام أن ورش إصلاح العدالة/القضاء عمل مستمر يستلزم إصدار العديد من القوانين التنظيمية والعادية لإنجازه.
– إن الأمر لا يتعلق بدور القضاء لوحده داخل منظومة العدالة، بل بكل الفاعلين في المنظومة، فقد انخرطت في هذا “الحراك” مختلف المكونات (وزارة العدل، قضاة، محامون، أعوان القضاء، كتاب الضبط …) وتحت مراقبة الرأي العام من خلال تدخلات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات ير الحكومية والإعلام بمختلف أشكاله.
– وأخيرا فإن إصلاح منظومة العدالة مرشح للمزيد من الانخراط في التوجه الدولي سواء على مستوى تسييس القضاء أو إخضاع السياسة للقضاء، ولا أدل على ذلك من عدد المجالات المتزايدة التي يتم إسناد الإشراف عليها للقضاء.
بن يونس المرزوقي
[1] – اقتصرت التعديلات اللاحقة على استبدال بعض المصطلحات بما يتلاءم مع الواقع الجديد، من قبيل استبدال مصطلح “المرسوم الملكي” بمصطلح “الظهير الشريف”، واستبدال مصطلحات “المحاكم الإقليمية” و”محاكم السد” بما يتلاءم مع التغييرات التي شهدها التنظيم القضائي.
[2] – تم إحداث هذه المحكمة بمقتضى دستور 1962، ولم يتم إلغاؤها إلا بدستور 2011. وقد كانت هذه المحكمة تتشكل من أعضاء ينتخبهم مجلسي البرلمان من بين أعضائهما على أساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين، وأن يُعين الملك رئيسها (الفصل 91)، كما أن التهمة يوجهها مجلس النواب (الفصل 89)، وأن البت في أمر المعنيين يكون بمجلس النواب وبالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم (الفصل 90).
[3] – قانون رقم 4.64 بتاريخ 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)، بإحداث محكمة العدل الخاصة يعهد إليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ المقترفة من طرف الموظفين العموميين. وقد تم إلغاؤها سنة 2004 مع إحالة القضايا التب كانت تنظر فيها إلى محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومكنس ومراكش.
[4] – ظهير شريف رقم 1.56.270، معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، صادر في سادس ربيع الثاني 1376 الموافق لـ 10 نونبر 1956.
[5] – بعد إحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960، تم إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب قانون 79.12 سنة 1979، ليتم دسترته بموجب دستور 13 شتنبر 1996، ليتم بعد ذلك إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.
[6] – صدر هذا الحكم بتاريخ 20 مارس 1970، وقد ورد فيه أن القرارات الملكية غير قابلة للطعن طالما أن الدستور لم يعهد إلى هيئة معينة بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذه القرارات، كما أن “جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور “.
[7] – الفصل 79 من دستور 1992.
[8] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
[9] – قامت الداخلية بالتقدم بمقال قضائي لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6 غشت 2007، يرمي إلى إبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وذلك استنادا إلى مقتضيات المواد 53 و4 من قانون الأحزاب السياسية. وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بتاريخ 07/04/2008 بإبطال الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي مع ترتيب الآثار القانونية.
[10] – تم النطق بحكم يقضي بإبطال تأسيس حزب الأمة بتاريخ 17 أبريل 2008، بعد أن كان قد تم إيداع ملف التأسيس بوزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر 2006، وعقد الحزب مؤتمره التأسيس بتاريخ 03 يونيو 2007. وقد رفضت وزارة الداخلية استلام ملف التأسيس. وقد توصل المعنيون بتاريخ 28 غشت 2007 بمقال افتتاحي من المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة وزير الداخلية يطلب هذا الأخير بمقتضاه إبطال تأسيس حزب الأمة. وهو ما تم فعلا من خلال حكم 17 أبريل 2007 بدعوى أن مسطرة التأسيس لم تكن قانونية.
وقد أعاد الحزب مسطرة التأسيس بعد صدور دستور 2001، بتاريخ 21 مارس 2012 حيث وضع ملفا جديدا للتصريح بتأسيس الحزب الأمة لدى مصالح وزارة الداخلية عن طريق المفوض القضائي. إلا أنه بتاريخ 14 ماي 2012 قدمت وزارة الداخلية من جديد طلبا يرمي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، ورغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28 يونيو 2012 قضى برفض طلب وزير الداخلية الرامي إلى إلغاء تأسيس حزب الأمة، فإن محكمة الاستئناف قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتالي إبطال عملية التأسيس.
[11] – تتمثل أهم مشكلة بالنسبة لهذا الحزب، في أنه رغم أن قرار حله تم بمقتضى مرسوم، فإن الحزب لم يتمكن من متابعة الموضوع أمام القضاء نظرا عدم وجود المرسوم بحيث أنه لم يتم لا نشره ولا تبلغه للمعنيين به.
[12] – القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).
[13] – القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
[14] – القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).
[15] – انظر الأجزاء الخاصة بالغرف المهنية في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه.
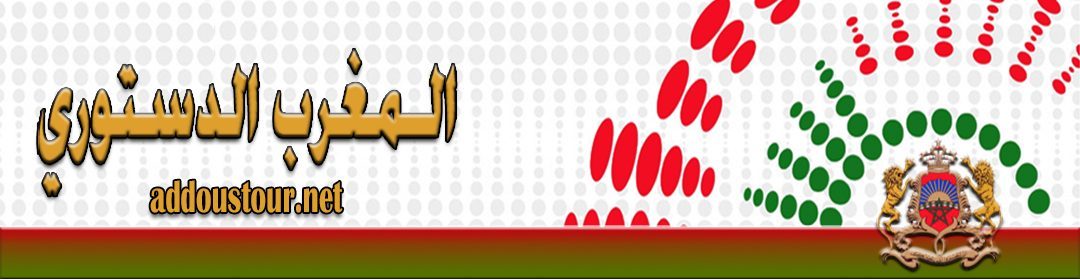
قم بكتابة اول تعليق